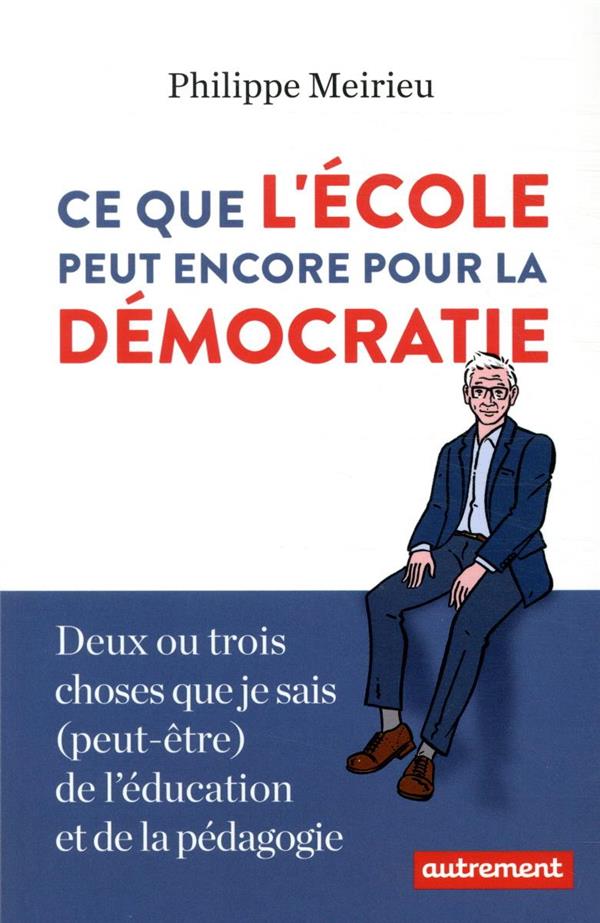
فيليب ميريو (1949) أحد أكبر المفكرين والخبراء في مجال البيداغوجيا وفلسفة التربية. تركزت أبحاثه بالمجمل حول السعي وراء تجديد التعليم، وإبراز دور مدرسة الغد، وتشريح الأزمة التي تعرفها التربية والتعليم في عصرنا هذا، وكذا ضرورة الانتقال من الطفل المستهلك إلى الطفل المواطن، إضافة إلى العديد من القضايا والإشكالات التي لها صلة بالموضوع. تقلد فيليب ميريو العديد من المناصب الأكاديمية، والمسؤوليات الثقافية والتربوية نذكر منها توليه: مديراً لمعهد علوم وممارسات التعليم في جامعة لوميير ليون. كما كان سنة 2006 هو الراعي الأساسي للمشروع الثقافي والتعليمي، لمدينة المعرفة خلال القرن الواحد والعشرين. وسبق له أن أشرف من سنة 2005 إلى 2009 على قناة تلفزيونية تعليمية، تعنى بكافة إشكالات التربية والتعليم. للباحث العديد من الكتب منها: “المدرسة أو الحرب المدنية” 1997، و”الآلة المدرسة” 2001، و”الكفايات في المدرسة، التعلم والتقويم” 2012، ثم “أن نتعلم نعم ولكن كيف؟” 2012. أما آخر كتاب له فقد صدر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وهو يحمل عنوان “ما يمكن للمدرسة أن تقوم به للديمقراطية” هذا إضافة إلى العديد من الإسهامات البحثية، في دوريات ومجلات تربوية متخصصة، دون أن ننسى المقالات والحوارات المنشورة على موقعه في الإنترنت.
أي أطفال سنترك للعالم؟
أزمة التربية
يتساءل فيليب ميريو أي أطفال سنترك للعالم؟ إن مبرر هذا السؤال يكمن في الوضعية القيمية والتربوية، التي يعيشها أطفالنا في هذه الحضارة، فهم في الغالب لهم عالمهم الخاص، المنفصل تماماً عن عالمنا، فهم غارقون في الشبكة العنكبوتية، والصور الافتراضية، مدمنون ألعابهم الإلكترونية، أو محنطون أمام أجهزة التلفاز. إن الاندفاعات الحيوية والنزوات، التي كانت مجرد مرحلة عابرة في حياة الطفل، أصبحت اليوم هي المبدأ المنظم والدائم لشخصيته. وما يعزز هذه الظاهرة هو المجتمع نفسه، من خلال الحث على الاستهلاك والتبضع. لذلك يجد الأطفال أنفسهم منجرفين، وراء تأثيرات الموضة والصور النمطية التي يروج لها الإعلام، مما ينتج عنه في نهاية الأمر، صعوبة قيام عملية تعليمية سليمة وفعالة، وإثارة الانتباه والتركيز على التحصيل الدراسي.
وهذا معناه أنه إذا كانت سلطة المدرس، المعرفية والتربوية قد تراجعت، فإن هذا الأمر له علاقة، بتراجع كل أشكال السلط التقليدية داخل المجتمع. لذلك لا يمكن أن نفهم ما يدور في المدرسة، دون ربطه بما يحدث في المجتمع ككل. بمعنى أن الأزمة تتجاوز الإطار الضيق للمدرسة، لكي تصبح أزمة اجتماعية وحضارية. في نظر فيليب ميريو، شباب اليوم يعاني من الإحباط لأن المجتمع لا يحقق انتظاراته. كما يؤكد أن حل هذه الأزمة، لا يمكن أن يكون عن طريق المزيد من تعزيز السلطة، ولا أيضاً بسن إجراءات تقنية، تختزل أزمة التعليم فيما هو بيداغوجي محض. من الضروري إذن الانتقال من الطفل المستهلك إلى الطفل المواطن، وهذا الأمر سيتحقق من خلال تكوين مجموعات عمل، تسمح لكل فرد بالتواجد والتعبير عن ذاته، بدل النظر إليه كموضوع إغراء. ينبغي كذلك تطوير تعليم ممتع وفني، يراعي احتياجات الطفل، والانخراط في مشاريع خاصة بدل “المطالبة بكل شيء”.
التربية والديمقراطية
يطالب فيليب ميريو من المجتمع أن يكون متضامناً، يسمح لكل فرد بأن يعيش مواطنيته كاملة. هذا معناه أن الكاتب يحمل مفهوماً خاصاً عن الديمقراطية، يختلف عما هو معروف، حيث يقوم جوهرها على مبدأ سيادة رأي الأغلبية على الأقلية. بدل هذا الأمر يرى الكاتب أن الديمقراطية الحقيقة، يجب أن تقوم على ضرورة تحقيق توازن صعب بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية. صحيح أنه ينبغي مراعاة الصالح العام، لكن هذا لا يعني السقوط في منطق إقصاء الأقلية، وخضوعها لسلطة الأغلبية. فمصلحة العيش المشترك، تتعارض مع مبدأ الخضوع والقوة المفروضة. إن هذا بالمجمل هو ما يميز عمل النظام الديمقراطي، الذي يقوم على نقاش مفتوح ودائم، وعلى غياب اليقينيات المطلقة.
ما علاقة هذا التصور للديمقراطية بالمسألة التعليمية؟
بالنسبة لفيليب ميريو هناك علاقة وطيدة بين الأمرين. ذلك أن المدرسة تعمل على تخريج أجيال من المتعلمين، تتفاوت في اختياراتها وانتماءاتها، وهذا هو ما يعكس صعوبة العيش المشترك. فالعلاقة إذن بين التعليم والحياة المجتمعية السليمة ديمقراطياً وطيدة الصلة. على المدرسة أن تراهن على تعليم شامل يحتوي جميع الفئات، وليس على تعليم نخبوي فئوي ينتصر فقط للقلة المحظوظة.
كتاب “ما يمكن للمدرسة أن تقوم به” (دار Autrement )
المهمة الصعبة للمعلم
في نظر فيليب ميريو تقوم مهمة المعلم على تحقيق أهداف صعبة ومتناقضة، فهو من ناحية أولى عليه أن يسعى، كي ينقل للطفل المعايير الاجتماعية الأساسية، بغرض تعزيز اندماجه في المجتمع، لكنه في الآن ذاته عليه أن يكسبه الحس النقدي تجاه هذه المعايير، حتى يستطيع فحصها ومراجعتها والتفكير فيها بطريقة شخصية. هكذا، فمهمة المدرس تعليمية وتثقيفية في الآن ذاته. إن المدرس يأتي إلى الفصل الدراسي، وهو مزود بشكل مسبق بالمعارف الجاهزة التي يود تلقينها للمتعلمين، غير أن هذا يجب ألا يمنعه أيضاً، من أن يكون مستعداً لأخذ ما يقدمونه له. فالتعلم هنا يكون ناجحاً باحترام شخصية المتعلم. لو اكتفى المدرس بنقل المعارف، فإنه سيكون في أحسن الأحوال حسب فيليب ميريو مجرد “ممثل أداء”. لذلك عليه أن يعتمد على طرق تدريس تكون “مؤقتة وقابلة لإعادة النظر”. فمهمته تكمن أساساً في تجاوز هذه التناقضات، والتغلب على التوترات الحاصلة بين الفردي والجماعي، وتحقيق التوازن المطلوب بين ما يميل إليه التلميذ وهو يسعى نحو فتح آفاق جديدة، والسلطة التي يملكها المدرس، والتي بالضرورة عليها أن تبحث هي أيضاً عما يحدها ويلطف من تغولها. فالمدرس ينقل المعرفة للمتعلم، لكنه في نفس الوقت يسمح لهم بالتغلب عليها إن أمكنه ذلك. لكل هذه الاعتبارات فمهمة المدرس جد معقدة وصعبة، إذ عليه احترام الآخرين، وفسح مجال الحرية لهم للتعبير عن ذواتهم وأفكارهم. لكن هذا الأمر قد ينطوي على خطورة استقالته وانسحابه من العملية التعليمية/ التعلمية، غير أن فيليب ميريو واع تماماً لهذه المخاطرة، وهو يصر دائماً على ضرورة تحقيق هذا التوازن الصعب بين العفوية والسلطوية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال، ترك التلميذ محروماً من التعليم والمعرفة، تحت ذريعة أن الأمر متروك له. إن المعلم عليه ألا يختار بين الحرية والسلطة، بل عليه أن يعمل طبقاً لمبدأ قابلية تعليم الجميع، بمعنى أنه عليه أن يختار تجاوز الحدين معاً والجمع بينهما.
يقول ميريو في أحد مقالاته “سيكون من الضروري تجاوز المرحلة البسيطة من الدروس أو المشاريع الفردية، التي تشير إلى أنه يمكننا إنقاذ الكوكب من خلال تقديم عدد قليل من الجيوب الفاضلة، دون تغيير أي شيء في المنطق الإنتاجي الذي يقودنا إلى طريق مسدود. يجب أن نسمح لأطفالنا بفهم أننا اتخذنا خيارات، وأن الخيارات الأخرى ممكنة. أكثر من ذلك: يجب السماح لهم بتجربة انعكاس جذري في علاقتهم بالعالم”.
تقييم نقدي
تظل أفكار فيليب ميريو محط جدل ونقاش كبير، فهو باعتباره أحد أكبر المدافعين عن ضرورة بلورة تعليم جديد، ودور سياسي واجتماعي للمدرسةـ وليس فقط دوراً تربوياًـ أصبح بسبب ذلك عرضة للانتقاد والهجوم من أطراف عديدة. فقد نظر إليه على أنه من الناحية العامة، يبدو أنه متأثر بدرجة كبيرة بطروحات جان جاك روسو خصوصاً كتاب هذا الأخير “إميل أو التربية” والذي يدعو فيه روسو إلى منح المزيد من الحرية للمتعلم، في اختيار ما يلائم ميوله، بدل نقل المعارف الأساسية له. وهكذا بالمثل اتهم فيليب ميريو بأنه يسقط في الطوباوية الروسوية، وفي الانسياق وراء أهواء الأطفال، والعمل على تقويض سلطة المدرسين، وبالتالي يسهم في انخفاض مستوى الطلاب. وأنه بأفكاره هذه يقود المدرسة نحو أزمة خطيرة، عندما يجعل الأطفال “ملوكاً” ويدفعهم إلى التجرؤ على انتهاك القيم الأساسية للمجتمع، وعدم احترام الكبار.
مع ذلك وعلى الرغم من هذه الانتقادات تظل أفكار فيليب ميريو ذات راهنية قوية، خصوصاً اهتمامه بمدرسة المستقبل، وبالدور الذي يجب أن يضطلع به المدرس، في عالم أصبحت الثورة الرقمية تسحب البساط من تحت رجليه. كما أن كشفه الجانب الخفي للمدرسة، الكامن وراء الهدف التربوي المعلن لها، والذي يتجلى في الدور السياسي الذي تلعبه داخل المجتمع، هو عودة للتذكير بالأطروحات الشهيرة لبيير بورديو، حول إعادة إنتاج النخب والحفاظ على التراتبية الاجتماعية التي تقوم بها المدرسة. إن هذا الموقف هو ما جعل فيليب ميريو أحد أكبر المدافعين عن ضرورة دمقرطة المدرسة. وعلى الرغم من أنه اتهم بأنه يدافع عن تصور ليبرالي للمدرسة، فإن اختياراته اليسارية كما يعلن عن ذلك واضحة، في ضرورة النظر للمؤسسة التعليمية كمؤسسة تسهم في تحرير المجتمع، وتكوين فرد قادر على المساهمة بفعالية إيجابية، في الحياة السياسية والاجتماعية لوطنه. وإذا كانت المدرسة تعرف أزمة كبيرة اليوم، فإن هذا راجع بالأساس إلى التحولات القيمية التي يعرفها المجتمع، أكثر مما هو راجع إلى النظريات التربوية التجريبية التي تتهم بأنها هي من كانت وراء هذه الأزمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-BPI

















